أسباب تمزق الأمة الإسلامية المحاضرة رقم 3
كتبت من محاضرة صوتية ألقيت قبل سنوات في سورية
تقدم على أنّ السبب والعلة لأي انحطاط في أي أمة من الأمم أو أي رقيّ لا يمكن أن يعود إلى سبب واحد، فإذا اجتمعت العوامل المختلفة كانت علّة واحدة لرقي أمة، أو لسقوط أمة، ومن المستحيل أبداً ومطلقاً أن ننسب كلما يعاني منه المسلمون أو تعاني منه الأمة الإسلامية إلى سبب واحد، كالمعرفة مثلاً، فمجرد المعرفة لا تشكّل أمة سليمة تسير إلى الرقي، فالمعرفة تحتاج إلى عمل متواصل، وتحتاج إلى زكاة نفس، وتحتاج إلى كثير من الأمور المختلفة في المقام، وقد أشار القرآن المجيد في كثير من المواطن إلى أنّ الأمم السابقة على الرغم من العرفان للحقائق ومع كل ما فهموه من الأنبياء المتقدمين ساروا على الضلالة والأخطاء، فلابد وأن يكون العلاج لكل أمة متكاملاً من جميع الجوانب حتى تتمكن الأمة من أن تنهض وتقوم بما تحتاجه من أجل رقيّها وسعادتها.
من قرأ الكتاب المجيد سيجده بين آونة وأخرى، بين سورة وأخرى، يعيد مسألة بني إسرائيل وما عانى منه موسى (ع) من الأهوال والصعاب، فلعل موسى (ع) كان يعاني من قومه أكثر ممّا كان يعانيه من الأقباط ومن فرعون، فمسألة فرعون انتهت بتدخل إلهي، فأباد الله فرعون وأهلكه في البحر، وأهلك من قابل موسى (ع) ، ورفع السدود من طواغيت قريش، رفعهم جميعاً وأهلكهم، فأباد رؤساء قريش إبادة تامة في بدر وغيرها، فأهلكهم، وبدعوة من رسول الله (ص) لمّا هدّد كسرى محمداً (ص) في نفس الليلة التي دعا فيها رسول الله (ص) قتل شيرويه ابن كسرى ذلك الطاغوت، فأراح المسلمين من شرّه، فقد أخذ الله تعالى لطفاً بحال العباد أن يرفع السدود أمام كلّ دعوة من أي طاغوت ومجرم حتى تنتشر الدعوة على وجه الأرض.
فالمشكلة ليست في طواغيت، ولا أيضاً في معرفة، فالمعرفة لكثير ممن عايش حملة الرسالة كانت واضحة، لقد وعوا الشريعة وفهموها بكل أبعادها، وتوصلوا إلى كثير من أعماقها، حتى قال علي (ع) : ( أما والله لقد تقمّصها فلان، وإنه ليعلم أنّ محلّي منها محلّ القطب من الرحى) ([1][1][1]) .
إنّ الإنسان الذي بلغ في المعرفة إلى هذا الحد فهو يعرف الحقيقة بتمام معنى الكلمة، فلابدّ من تداعي أسباب كثيرة تجتمع، فإذا اجتمعت الأسباب الكثيرة كانت سبباً لأمر من الأمور.
فالمشكلة الكبرى التي هي أمّ المشاكل هي حضارات المجتمع، فبنو إسرائيل فهموا حقيقة الأمر من موسى (ع) ورحمهم الله تعالى حينما أهلك جباراً من جبابرة الأرض، وشاهدوه بأمّ أعينهم، فكانت المعجزات، وكانت الأمور واضحة لبني إسرائيل، فلمّا جاوز بهم موسى (ع) البحر وجدوا قوماً يعكفون على أصنام لهم، فطلبوا من موسى (ع) مخفّفين عليه الأمر: يا نبي الله لهؤلاء أصنام كثيرة متعددة، لا نريد منك أن تفتح أبواب الصنمية كما لهؤلاء فتجعل لنا آلهة، نريد فقط صنماً واحداً، فيرون أنفسهم لم يثقلوا على موسى (ع) ؛ لأنّ للقوم أصناماً، فما أرادوا أصناماً كثيرة يعبدونها، فخففوا وتساهلوا مع موسى (ع) ، فأرادوا منه فقط أن يجعل لهم صنماً واحداً يعبدونه؛ لأنهم يريدون محسوساً، ولم يتمكّنوا من عبادة إلهٍ معقول، فنهض موسى (ع) وذكّرهم بالله العظيم، وما منّ به عليهم من تخليصهم من فرعون وإهلاك فرعون، فكادوا أن يتوبوا، فذهب موسى بعد فترة من الزمن لمناجاة ربّه ووعدهم بثلاثين ليلة، فأراد الله أن يختبر الأمة التي تدّعي أنها أصبحت من أتباع الأنبياء باختبار جديد، فأضاف عشرة فجعلها أربعين.
فالروحية روحية جهل، والحضارة جاهلية، والعقول غير سليمة، فعادوا مرة ثانية ليعبدوا العجل، فعبدوا العجل بمكيدة من السامري، ولولا أنّ العقلية عقلية جاهلية لما كان من الممكن أن ينحطّ صاحب العقل والرقي من عظيم مقام التوحيد إلى دناءة وذلّ عبودية الأصنام في عشرة أيام، فجاء موسى (ع) فلم يجد قومه على ما عاهدهم عليه، ثم تابوا إلى ربهم كما يدّعون، ومن بعدما نصحهم مرّ الزمن مرة ثانية ليكشف أنّ الأمة كانت أمة جاهلية، وليست بأمة مسلمة؛ لأنّ الدين عند الله الإسلام، فما جاء آدم (ع) ولا نوح ولا إبراهيم ولا موسى ولا عيسى ولا محمّد عليهم جميعاً أفضل الصلاة والسلام إلاّ بشريعة السّلام والاستسلام للحق، فطالبوا موسى مرة ثالثة بعد كل هذه الأمور أن يروا الله جهرة!
فالعقلية عقلية محسوس، لا تدرك المعقول، فبعد كل هذه المراحل وطلب صنمية ورجوع إلى عجل يأتون في المرحلة الثالثة ليحكّموا أعماق حضارتهم الجاهلية فيطلبوا من موسى (ع) أن يروا الله جهرة، أي: ينظرون إليه ببصرهم الحسي، لا بمدركاتهم العقلية.
إنّ الله سبحانه وتعالى ما جاء بهذه القصص في الكتاب المجيد ليذكر قصصاً في كتابه، وإنما جاء بالعبر والحضارات الجاهلية في مقابل حضارة الإسلام، فهي حضارات وليست بأمور يمكن أن تتبدّل في يوم وليلة و { لايغير الله ما بقوم حتى يغيّروا ما بأنفسهم} ([2][2][2]) .
وقلنا: من شأن النفوس التي تعيش جهلها المركب، والمراد منه أن يتصور الإنسان بجزم الخطأ صواباً، فهو قد وصلت نفسه في مرحلة من الجهل أن يرى نفسه عالماً مع جهله، فقد سدّ أمام نفسه جميع الأبواب ومشاهدة الحقائق.
وليس ببعيد علينا في التاريخ ما جرى في الحرب العالمية الثانية، وما وصل إليه أمر اليابان وألمانيا من الدمار والشتات والقتل والاضطهاد الذي عانته هذه الشعوب، فما جلس الألمانيون ولا اليابانيون ليلقي بعضهم اللوم على بعض، بل نسوا المأساة، ومن أخطأ فيه، وجاؤوا مجدّين مصرّين ليعودوا مرة ثانية أمة تقابل الأمم، وإذا بهم مع كل ما عليهم من الحصار والدمار وما دفعوا إلى المتسلطين من أموال و ضرائب وإذا بهم اليوم يواكبون العالم مرة ثانية بعد خمسين سنة أو أقل من ذلك. مَن سبب دمار ألمانيا واليابان؟ ومن هو المسؤول؟ ومن سيُسأل؟ جعلوه في سجل الغابرين الماضين وجلسوا جلسة رجلٍ واحد وأمة واحدة برجالهم ونسائهم ليؤسسوا للمستقبل، ويعتبروا من الماضي، هكذا تكون الشعوب التي تريد أن تتحرك، فعلينا أن نترك من أوصل الأمة إلى ما وصلت إليه، هل هم علماؤها أو حكامها أو مجتمعها أو تجارها، فهذا أمر انتهى وتجاوزناه، ولا ندري اليوم هل نحن نعيش حضارة المغول الذين احتلوا البلاد الإسلامية فظنناه إسلاماً، أو نعيش حضارة بني أمية وبني العباس الذين حكموا تحت عنوان الإسلام، لا ندري؟
فلنا موروث بأيدينا يسمى إسلاماً، بعاداته وحضارته وشؤونه المختلفة، فعلينا أن نترك ماذا فعل بنو أمية وبنو العباس ومن سبقهم أو لحقهم من دمار لهذه الأمة، فهو سجلّ انطوى وذهب، فإن كنا رجال حقّ ونريد بناء مجتمع على أسس سليمة وصحيحة بأن نبحث عن أسباب الانحطاط لنعالج الانحطاط، ونبحث عن أسباب رقي الأمم لنواكب الأمم، والله سبحانه وتعالى ما أمرنا يوماً من الأيام أن ننسى نصيبنا من الدنيا، وقد ورد في الأحاديث: ( اعمل لدنياك كأنك تعيش أبداً، واعمل لآخرتك كأنك تموت غداً) ([3][3][3]) ، فهناك موازنة بين نصيب الدنيا والآخرة، ولا يعقل أن يكون الإنسان بما يحمل من مناهج الدين والمعارف يتمكن أن يتوصل إلى العز والرقي وهو يعيش ذلاًّ اقتصادياً أو عسكرياً، أو جهلاً في فهم مسائل الشريعة، فهذه أمور مرتبطة إذا لم تجتمع لا يمكن أن تصنع أمة سليمة تتمكن أن تقابل الأمم.
فلابد أن نبدأ من يومنا هذا تاركين الماضي بكلّ ظلماته، داعين بعض شبابنا ليصيروا أخصّائيين في الاقتصاد الإسلامي، ولينظروا إلى محاسن الاقتصاد الإسلامي بعمقٍ ودراية حتى إذا جلسنا جلسة مع غيرنا نقول: هذا هو الاقتصاد الإسلامي في مقابل الاقتصاد الشيوعي أو الاشتراكي والرأسمالي، ثم نبيّن المزايا الإسلامية، ونخرج الاقتصاد من مرحلة الفرضية إلى مرحلة التطبيق، ليكون واضحاً ملموساً لجميع الناس على وجه الأرض، وهكذا نحتاج إلى خبراء وأناس يسيرون في جميع مجالات الحياة حتى يصبح الدين حقيقة مطبقة على واقع الحياة.
فالإسلام كسلسلة واحدة مترابطة لا يكون حسناً بحلقة واحدة دون ترابط الحلقات، كما وأنه لا يمكن أن يتهاوى لسببية واحدة، فقد جاء الإسلام وأمر بصراحة من القول أن تقطع يد السارق مثلاً فبمجرد أن يسمع القاضي أنّ هذا سرق شيئاً يبادر لقطع يده متبجّحاً مفتخراً أنه طبّق شريعة محمّد (ص) في إقامة الحدود، ويفتخر ذلك الحاكم في البلاد أنه بحمد الله على عهده طبقت شريعة رسول الله (ص) ، وأنه في عهده أقيمت الحدود، ويصعد الخطيب متبجّحاً مفتخراً على أنه بحمد الله في بلادنا نرى عزّ الإسلام بقطع يد السارقين، ويتكلم التاجر والفلاّح وكل واحد على ما يناسبه في المقام على أنّ بلادنا بحمد الله تقيم عدل الله والحدود، في حين أنّ القاضي نسي وكذا الحاكم والتاجر قد يكون فخوراً والحال لا تقطع يد السارق إن كان محتاجاً، ولا تقطع يد السارق إذا كان جاهلاً، فنسي العالم وظيفته، فهل قام ببيان الشريعة وصار كرسول الله (ص) ( طبيب دوار بطبّه) وصار يسير بسيرة المعصومين ? كالإمام الصادق (ع) ينتقل من قرية إلى قرية يفقّه الناس في دينهم؟ فهو قد وعى أمراً ونسي أموراً، ونسي العالم وظيفته فراح لينظر متعالياً إلى سارق فقير محتاج كيف سرق، وحمد الله وشكر نعماءه عليه أنه في زمانه قطعت يد السارق، وراح ليستبشر التاجر حينما سمع أنّ السرّاق في البلاد الإسلامية تقطع أياديهم ليأمن على ماله حتى لا يتعرّض إلى السرقات، ونسي أنّ هذا السارق ربما سرق حينما منعه حقّه التاجر أو الحاكم، فالسارق إذا كان محتاجاً لا تقطع يده، فلما ترك العالم علمه ولم يبيّن وترك التاجر بَذْله فجعله محتاجاً، وترك الحاكم عدله فلم يساو بين الرعية في عدلـه، وقد مرّ علي (ع) يوماً من الأيام في سوق الكوفة فوجد إنساناً سائلاً مادّاً يده يستجدي فوقف (ع) متعجباً متغيراً متأثراً، كيف يجد في زمن حكمه فقيراً يستجدي الناس في الشوارع، فقال لـه: يا عبد الله لِمَ تستجدي؟ قال: يا أمير المؤمنين ساقني الفقر والحاجة، ولست من المسلمين، فازداد تأثّر علي (ع) ؛ لأنّ المستجدي كان يظنّ أنّ هذا نتيجة عدم إسلامه، فيجب أن لا يساوى بينه وبين بقية المسلمين في العدل والعطاء، فقال (ع) : أخذوا منك الجزية يوم كنت قوياً، وتركوك في الشوارع ذليلاً تستجدي حينما اصبحت عاجزا! عليَّ بصاحب بيت المال، فالمحكمة لم تطل أشهراً أو سنيناً، بل قال: الآن عليَّ بصاحب بيت المال، فجيء به، قال: لِمَ أجد هذا يستجدي ويدّعي الفقر، أفقير أم لا؟ قال: نعم، قال: كيف أخذتم منه الجزية حينما كان قوياً وتركتموه عاجزاً يستجدي في الشوارع؟ أما والله إن وجدت فقيراً بعد اليوم أقمتُ عليكَ حدّ الله.
فالحدود يقيمها على خازن بيت المال، ولم يتسارع إلى لوم هذا الفقير، ولم يتسارع إلى قطع يد سارق فقير، فالسارق هو ذلك العالم بالحكم غير المحتاج الذي يحب السرقة عدواناً على المجتمع، وهذا عضوٌ فاسد في المجتمع، لا من دعاه الفقر أو الجهل إلى سرقة.
وهكذا رحنا نتسارع لو وجدنا شاباً دفعته الحاجة أو رغبته الجنسية إلى الزنا، ونسينا مغالات في المهور والصداق ونسينا دوافع القبلية التي بها رددنا هذا الشاب حينما جاء خاطبا، وقلنا: مَن هو هذا الفقير المسكين حتى يعطيه الحاج الفلاني أو السيد الفلاني؟ ونسينا الكثير من الأمور، ولعله خطب فتاة يحبّها فمنعناه، فاندفع بدوافع أخرى ليرتكب خطأ أو جريمة، فتناسينا كلّ أخطائنا لنتحامل متظاهرين بمظاهر الزهاد والمتقين: أنه كيف يرتكب هذا الشاب هذه الجريمة؟ وعندنا مهور مرتفعة وقبليّة حاكمة لا تعطي أيّ أحد، ونسينا قول رسول الله (ص) : ( إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوّجوه) ([4][4][4]) ، والكفاءة في الدين لا الكفاءة في القبلية وغيرها، ولا في المال ولا … ، فنسينا ألف حكم وشريعة وجئنا كزهاد متعجبين من فعلة إنسان ساقته الكثير من العوامل، فالواحد منا يصعد المنبر وقد تزوّج الثلاثة والأربعة ويجلس متعالياً من شاب فقير كيف زنا، ولم تنظر إلى نفسك بأنّك جوّزت لنفسك الواحدة والثانية والثالثة والرابعة، ورحت لتتمتع وراء ذلك، ونسيت شاباً فقيراً في سن المراهقة، فاستغربت منه كيف اندفع إلى هذا الفعل، ونسيت العديد من الأسباب!
فهذه هي مأساة الأمة بأن تنظر إلى جانب وتغفل عن جوانب كثيرة أخرى.
وهناك أمور لها الدخل في كثير من مسائلنا:
أضرب مثالاً لها: يقول الحديث: ( حلال محمّد حلال أبداً إلى يوم القيامة، وحرامه حرام أبداً إلى يوم القيامة) ([5][5][5]) ، وشريعته خاتمية لا تتبدل ولا تتغيّر، ولا أظن أنّ مجتمعنا غريب عليه اسم صدر المتألهين النابغة الإسلامي العظيم والفيلسوف الذي لا ينكره أحد، فهذا الرجل العظيم مع كل ما هو عليه أعطيناه فترة من الزمن لقباً ثم بدّلناه بتشهيّاتنا ورغباتنا فأعطيناه لقباً آخر، فقبل (350) سنة كان الرجل في حوزاتنا وعند كثير من علمائنا يعدّ كافراً وأبحنا دمه، ففرّ من أصفهان ليلوذ بقرى في أطراف قم، وراح الناس يسأل بعضها بعضاً: أين هذا الزنديق لأتقرب إلى الله بقتله؟ فاختفى الرجل وتنكّر في البلاد ينتقل من مكان إلى مكان، والسواد الأعظم يريد أن يتقرّب إلى الله بدم هذا الزنديق الكافر، فمرّ أكثر من (200) عام وهو في سجلّ الزنادقة الكفرة المرتدّين، ثم جئنا في القرن الأخير لنسمّيه ( صدر المتألهين) ، وليس هناك نسبة بين ( صدر المتألهين) اليوم ــ يعني: الذي لـه صدارة التألّه أي التوغّل في الدين والمعارف، وأنه مفخرة من مفاخر البشرية فضلاً عن كونه مفخرة إسلامية شيعية ــ وبين الزنديق والكافر بالأمس!
فلابدّ أن نرجع مرة ثانية ونقبل الواقع: أنّا في بعض الأحيان نندفع اندفاعة سريعة في الحكم، فنحرّم الراديو والتلفاز حرمة مطلقة يوماً، ويدخل في بيوتنا اليوم، فهل تغيّر حلال محمّد (ص) وحرامه أم لا؟
فقد نخلط بين تشخيص الموضوعات وبين الأحكام، فنقع في ارتباك ومشاكل مختلفة، فيجب علينا أن نبدأ بأنفسنا قبل أن نلقي اللوم على الآخرين.
[6][1][1]ــ نهج البلاغة، شرح محمد عبده 1 : 30 ، خطبة رقم 3 وهي المعروفة بالشقشقية.
[7][2][2]ــ سورة الرعد، الآية 11 .
[8][3][3]ــ من لا يحضره الفقيه، الشيخ الصدوق 3 : 156 ، ح 3569 .
[9][4][4]ــ الكافي، الشيخ الكليني 5 : 347 ، ح 2 .
[10][5][5]ــ الكافي، الشيخ الكليني 1 : 58 ، ح 19 .






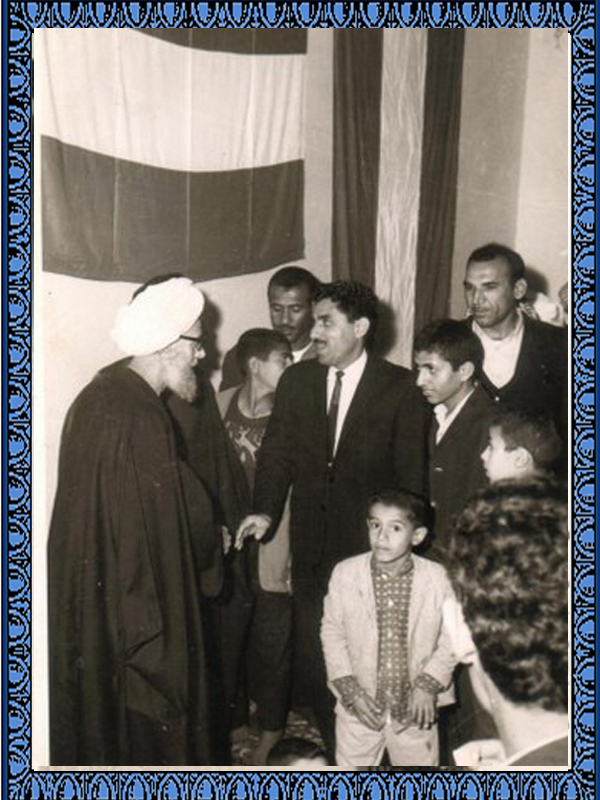


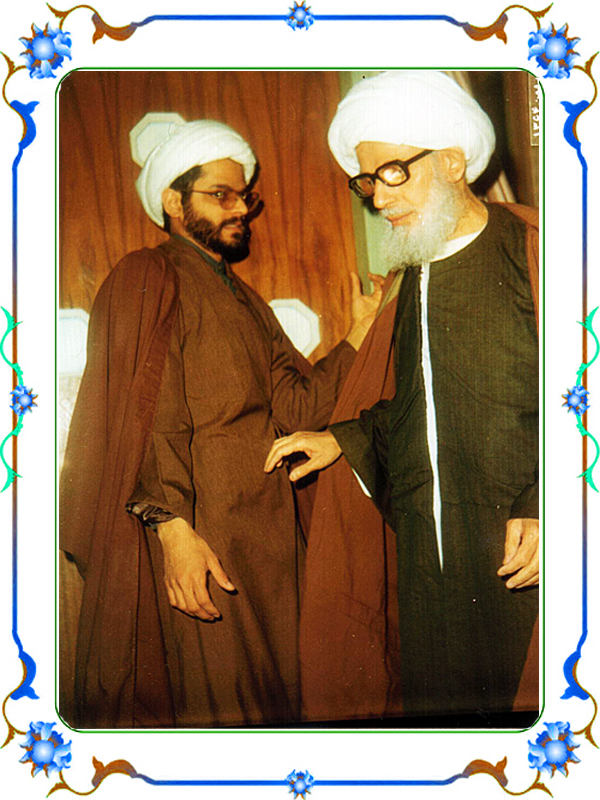
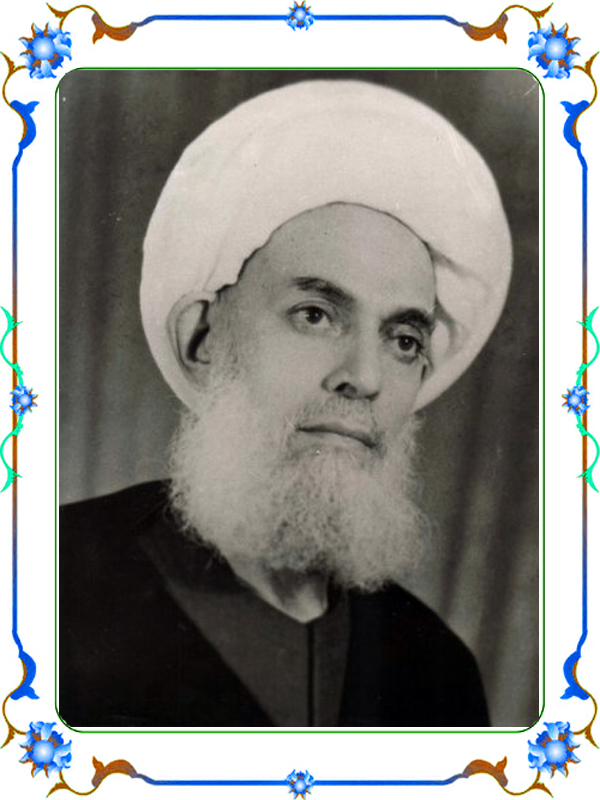
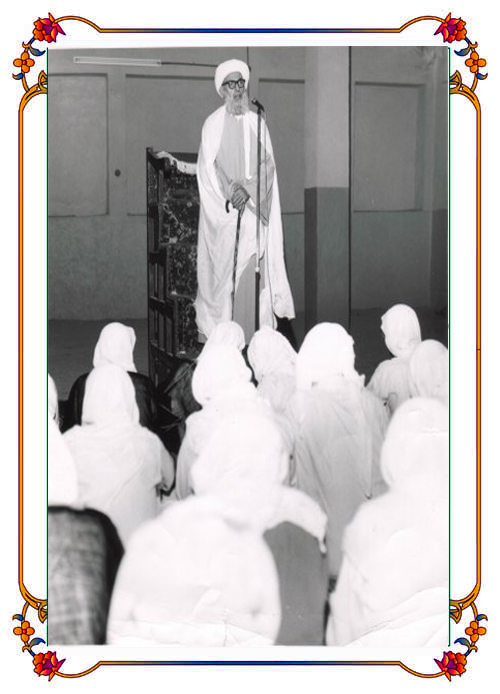

0 تعليق